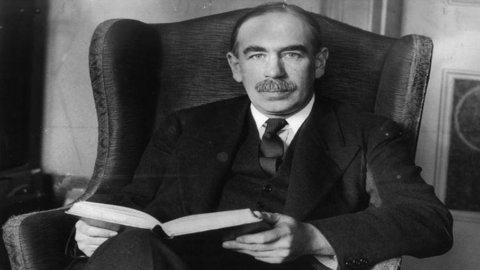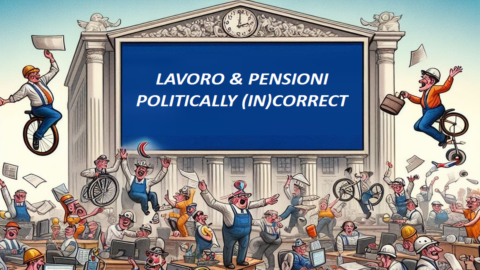اعتقد كينز - ليس من دون صفة خادعة إلى حد ما لقارات جزيرته - أن مونتسكيو كان أعظم اقتصادي فرنسي ، عندما تم الاحتفال به في فرنسا لمزايا أخرى. الكل في الكل ، كان لدى كينز سبب وجيه. يمكن للمرء أن يعلق في حدس البارون دي سيكندات إي دي لا بريدي حول العلل الإيطالية. في عصره ، كانت إيطاليا وألمانيا فقط "مقسمة إلى عدد لا حصر له من الدول الصغيرة" مع حكومات "شهداء السيادة" للآخرين. لقد سحقت الدول العظيمة الموجودة كل نبتة من تلك السيادة التي تظاهرت الدول الصغيرة بممارستها دون أن تنجح. كل هذا كان له أيضًا تداعيات كبيرة على الأمور الاقتصادية وليس السياسة فقط. تم تخفيض الأمراء الإيطاليين إلى النصف في أمور العملة والجمارك والضرائب ، وبعبارة أخرى ، صناعة وازدهار رعاياهم.
يهدد العصر الحالي للعولمة بإعادة اقتصادنا إلى وضع مماثل. بذلت إيطاليا المتحدة جهدًا كبيرًا لتحرير نفسها من حالة العبودية تجاه القوى الأجنبية. وببطء فقط ، أفلت بلدنا من مصير تميزت به القوى العظمى بالكامل. مر الاستيلاء على السيادة بعملية انتعاش سياسي ، ولكن تم تأكيده فقط بشرط أن تعرف الحكومات الوطنية كيفية إنشاء بيئة إقليمية للتعايش المدني تسمح للجميع بالسعي ، بسلام وأمن وحرية ، وتحقيق أهداف الازدهار وفقًا لصفاتهم الخاصة من المهارة والذكاء والاجتهاد. تضمن الدولة أن الاجتماعية ضرورية لتنمية المهارات. كان تحقيق السيادة الاقتصادية شرطًا للقدرة على متابعة السياسات الاقتصادية بفعالية وفقًا للأولويات التي وضعتها الحكومات المتعاقبة. في المصطلحات الحديثة ، يمكن تحقيق العمالة الكاملة والاستقرار النقدي والازدهار على نطاق واسع ، وفي جزء كبير منها لا يتحقق إلا إذا كان من الممكن تجنب ما يسمى في الاقتصاد "القيود الخارجية" لميزان المدفوعات مع الخارج والأجنبي. تبادل. كانت السيادة هي شرط القدرة على الرغبة والقرار ، وإلا فإن كل شيء كان عبثًا ولم يتبق سوى الخضوع.
إن فهم شروط البداية ليس ذا فائدة كبيرة في فهم تلك التي نجد أنفسنا فيها اليوم. يساعدنا Montesquieu مرة أخرى من خلال الإشارة إلى جانبين: الكتلة الحرجة ودرجة الانفتاح. في القرن الثامن عشر - يذكرنا ساخرًا - كان لبعض دول شبه الجزيرة رعايا أقل من محظيات بعض السلاطين الشرقيين. كان لذلك عواقب اقتصادية وسياسية ليست لها أهمية كبيرة. الدول الأصغر من أن يكون لها أي ادعاء بالسيادة كانت بالضرورة "منفتحة كقوافل" ، ملزمة باستقبال أي شخص والتخلي عنه. في مثل هذه الأنظمة ، غالبًا ما كانت حرية "المرور" مقترنة بأنظمة سياسية قمعية للسكان: "مجتمعات مفتوحة" بمعنى واحد فقط. لإنشاء نظام قطري ، كان من الضروري تنظيم مثل هذا الوضع الفوضوي الذي لا يرغب فيه أحد بجدية في أن يتجذر بمودة ورأس مال. كان شتات المفكرين الإيطاليين في ذروته في ذلك الوقت واستمر بعد ذلك ، مع وجود قوسين في أول 700-50 سنة بعد التوحيد وفي العقود الأولى بعد الحرب العالمية الثانية.
في معجم القرن الثامن عشر ، كان أولئك الذين استقروا في منطقة ما ، بشكل دائم أو مؤقت ، يتميزون بالأمة في إشارة إلى الأصل واللغة والعادات. البلد من نوع القوافل ، الذي يفتقر إلى ius loci ، اقتصر على استضافتهم. حتى السكان الأصليون لم يشعروا بأنهم في وطنهم.
لم يتم الوصول إلى كتلة حرجة معينة في إيطاليا إلا بعد التوحيد ، ولكن اليوم لم يعد الأمر نفسه كافياً لمنح الوطن والسيادة. هذا ينطبق أيضًا على ألمانيا. أوروبا هي كتلتنا الحرجة التي لا مفر منها حتى لا نجد أنفسنا في القوافل مرة أخرى. واجهنا خطر التراجع عنها ، ورأينا أيضًا النتائج التي يمكن أن تنجم عن السياسة باعتبارها تبادلًا للملذات ومن القانون كأداة للسلطة ، وتأكدنا من أي رعايا يسجد رئيس حكومة لنفسه. طريقة ذليلة مع الذي طلب العلاج في المنزل. إذا أراد بلد ما الخروج من السربانيات من النوع الشرقي ولم يقبل أن سيادة الآخرين هي التي تقرر مصيرها ، فمن الضروري أيضًا أن تستأنف (مع أوروبا) تلك المهمة الشاقة المسماة الوطن ، المكتملة جزئيًا مع ايطاليا. بعبارة أخرى ، إنها مسألة بناء ليس فقط اتحادًا بل نظامًا للتضامن يتم فيه احترام العدالة ومنحها ، والسمعة التي يتم تكريمها على أساس الجدارة التي يظهرها كل واحد ويحدث نفس الشيء بالنسبة للاعتراف الصحيح الذي يتعين منحه إلى الالتزام المدني والاجتماعي الذي هو ثمرة تعاون جماعي مستمر. بدون الوطن هناك القوافل.
هناك مخاطر أخرى من العودة إلى ذلك القرن الثامن عشر من الدول الصغيرة ، ومراكز السلع التجارية ومفترق طرق التجار ، تحت رحمة "انعكاسات ونزوات القدر". الاتحاد الأوروبي نفسه ، كما هو ، لا يساعد. الحماية من الانتكاسات وأهواء القدر ، اليوم كما في ثقافة ما قبل قرنين أو ثلاثة قرون ، تُترجم إلى حماية الأسواق ومنها. فمساحات العمل السياسي موجودة هناك. تعد حماية الأسواق حاجة واضحة اليوم وتتوافق مع تعزيز التكامل والتشغيل السليم لآليات الأسواق المفتوحة والتنافسية. في الاقتصاد الجيد ، لا تنتمي السيادة إلى الأسواق ، بل للمستهلكين (السوق أداة وليست قيمة) ، كما يمكن تعلمه من أي كتاب اقتصادي أساسي. لكي تكون اقتصادًا جيدًا حقًا ، من الضروري أن تعرف السيادة ، الشرعية ، كيف تدافع عن نفسها من الأسواق عندما تكون هذه الأسواق بعيدة كل البعد عن العمل بشكل جيد ومن أن تكون مفتوحة كما ينبغي. في عام 700 ، كان انهيار بنك كبير مثل Lehman Brothers كافياً لخلق أسوأ أزمة منذ عام 2008. توضح قضية بنك ليمان أن الأزمة المالية ، هذه المرة ، لم تحدث من خلال العدوى ولكن من خلال الانهيار الأرضي لركيزة لم تكن تعتبر حاملة للأعباء. إن مهمة جعل الأسواق تعمل بشكل جيد ليست بالمهمة السهلة ، لكن المهمة الثانية أصعب بكثير: حماية الاقتصاد والمجتمع. لقد أظهرت أزمة الديون السيادية في أوروبا كل حدود وعدم اكتمال المشروع الأوروبي من وجهة النظر هذه. يهيمن البعد الحالي للتمويل والأسواق المالية على أبعاد الدولة كما كان في زمن مونتسكيو وحتى قبل ذلك. في المجال المالي على وجه الخصوص ، فإن القوة السوقية التي حققتها بعض التكتلات في العقود الأخيرة غير مقبولة بسبب تعليق قانون الإفلاس ضدهم وخطر مراجعة سيادة الدول التي صادرها التجار والمصرفيون (مرة أخرى في هذا تاريخ السيادة. يجب أن تعلم اللغة الإيطالية). لم تعد الرأسمالية بدون إفلاس رأسمالية. يقوم شخص ما بتشغيل اللعبة عندما يتحول الفشل إلى ابتزاز يشكك في بقاء السوق نفسه ، مع كل العواقب الاجتماعية للقضية.
في مواجهة ذلك ، لم تقم أوروبا بحماية اقتصادها من أزمة الأسواق المالية ومن المضاربات التي استحوذت عليها. سرعان ما تلاشت حقوق المواطنة في منطقة اليورو (لا تزال غير محددة) مما يدل على أنه ليس نفس الشيء أن يكون لديك إقامة في جزء أو آخر. وقد تم إبراز الاختلالات الموجودة مسبقًا (وعدم التقارب) في ظل عدم وجود قواعد ضبط دقيقة ، تم وضعها مسبقًا. ساد المنطق القديم لانتقام النمل على السيكادا. أوروبا في حال وجودها لا تحمي الأسواق ولا تحمينا من الأسواق والمخاطرة بأن يجد الجميع أنفسهم في بيوتهم المتنقلة موجودة.
منذ القرن الثامن عشر ، بدأت بعض الدول الوطنية في بناء سيادتها الخاصة بعد إنجلترا في وقت متأخر ، والتي ، بالإضافة إلى الثورة السياسية ومبدأ سيادة القانون (أي أن تحكم وفقًا للقانون) ، قد وهبت نفسها ببنك من إصدار دين عام موحد ومقاوم للتقصير لإنقاذ الدولة من استبداد الأسواق. لا يزال يتعين على أوروبا اليوم أن تكمل نفس الخطوة حتى لا تخون تقاليدها في الحضارة المفتوحة. كما يعني أيضًا وضع القانون فوق كل شيء وعلى الجميع ، بدستور لا تمليه جماعات اللوبي والتجار ، وإلا فإن الخطر يكمن في الانحدار أكثر إلى الوراء ، إلى إقطاعية فخمة ، متصلة عبر الإنترنت ، ولكن بأشكال جديدة. من التبعية والسخرة. ما هي ميزة استبدال عالم الفرسان ورجال الدين والفلاحين بعالم جديد ، كل التكنولوجيا ويتكون من ثالوث مثير للقلق وأقل رومانسية من الشركات التجارية التي تطارد الإيجارات ، والبيروقراطيين المستعدين لتقديمها لهم ، وجماهير البروليتاريين الفاسدين؟ حتى بهذه الطريقة ، ستكون القوة الحقيقية والتعسفية في مكان آخر ، مع مصير ينزلق مرة أخرى بعيدًا عن أيدينا.